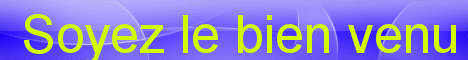molay
مدير مراقب
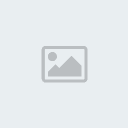


البلد : المغرب
الجنس : 
عدد المساهمات : 11945
تاريخ التسجيل : 17/12/2009
الموقع : STARMUST2
بطاقة الشخصية
الدرجة:
    (1365/1365) (1365/1365)
 |  موضوع: آثار الإيمان على الفرد والمجتمع - عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ / الرياض موضوع: آثار الإيمان على الفرد والمجتمع - عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ / الرياض  الخميس 2 فبراير - 2:56:11 الخميس 2 فبراير - 2:56:11 | |
|
آثار الإيمان على الفرد والمجتمع
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ / الرياض
الخطبة الأولى
أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حقّ التقوى.
عباد الله، إن الإيمان بالله وتوفيق الله للعبد لهذا الإيمان نعمة من أجلّ نِعَم الله على عبده، يقول جلّ وعلا: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [الحجرات:7، 8]، ويقول جلّ وعلا: يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ [الحجرات:17].
أيها المسلم، فنعمة الإيمان من أجلّ النِّعَم ومن أكبرها وأفضلها، أن يمنّ الله على العبد بهذا الإيمان، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ، حبّبه لنفوسكم، زيّنه في قلوبكم، فقبلت قلوبكم الحق، واطمأنّت به النفس: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ [الزمر:22].
أيها المسلم، يا مَن مَنَّ الله عليه بالإيمان بالله ورسوله ودينه، فاحمد الله على هذه النعمة، واعلم أنها من أجلّ النِّعَم وأكبرها وأعظمها شأنًا، حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ثم ذكر نعمته عليهم بأن كرَّهَ لهم ما يُضادّ الإيمان أو يُضادّ كماله، فقال: وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ فَضْلاً مِنْ اللَّهِ وَنِعْمَةً [الحجرات:7، 8]. أي هذا الإيمان وكراهية الكفر والفسوق والعصيان فضل من الله عليكم، لم تدركوه بقوّتكم، ولكن بمنّة الله وهدايته واختيار الله لكم لهذه النعمة أن جعلكم من أوليائه وعباده المؤمنين: وَلَوْلا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً إِذًا لأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا [الإسراء:74، 75].
أيها المسلم، يقول : ((ذاق طعم الإيمان مَن رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا رسولاً))[1]. فمن رضي بالله ربًّا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًا رسولاً؛ فقد ذاق طعم الإيمان، ووجد حلاوة الإيمان، فليحمد الله على هذه النعمة.
أيها المسلم، هذا الإيمان إذا استقرّ في القلب، واطمأنّت إليه النفس، فهذا إيمان نافع، إيمان ملأ القلب، فانقادت الجوارح بالأعمال الصالحة، ونطق اللسان بالحق والهدى، فتلك النعمة الكبرى والمنّة العظمى.
أيها المسلم، لهذا الإيمان الصحيح آثاره على العبد في حياته وفي آخرته، فمن أعظم آثاره على العبد أن يكون العبد عبدًا لله حقًّا، مخلصًا لله دينه، عابدًا الله على علم وبصيرة: أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ [محمد:14].
إذن فمن آثاره أنّ العبد يعبد الله على بصيرة، يعلم أن ربه خالقه ورازقه، وأن ربه موصوف بصفات، وله أسماء حسنى، وأنه المستحق أن يُدعى ويُرجى ويُخاف ويُستغاث به ويُستعان به، وتَتَعَلّق القلوب به محبّة وخوفًا ورجاءً.
من آثار ذلك الإيمان كون المؤمن مُصدِّقًا بالله، مُصدِّقًا بما جاء عن الله، مُصدِّقًا برسول الله : آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ [البقرة:285].
ومن آثار ذلك الإيمان قوة حبّ المؤمن لإيمانه، وأن هذا الإيمان في قلبه أغلى من كل شيء، فمهما حُمِل عن ترك الإيمان فهو ثابت عليه مستقيم عليه، أحبّ الإيمان ورضي به، وفي الحديث عنه : ((ثلاث من كُنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواهما، وأن يحبّ المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يُقذف في النار))[2].
ومن آثار ذلك الإيمان أنك ترى المؤمن ثابتًا في مواقفه، ثابتًا على مبادئه، ثابتًا على قِيَمه وفضائله في أي أرض كان وفي أي مجتمع كان، فلا الشهوات تقوده، ولا الشبهات تخدعه، فعنده عقل، فعنده بصيرة نافذة لا تستطيع الشبهات أن تؤثر عليه بتوفيق من الله، ولا يستطيع دعاة الباطل والضلال أن يؤثّروا عليه، وعنده عقل كامل أمام الشهوات، فلا يميل إليها خوفًا من الله، وعلمًا باطلاع الله عليه، لا خوفًا من الدنيا ولا خوفًا من عقوبة، ولكن خوف من اطلاع الخالق العالم بالسرائر والخفايا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ [الرحمن:46].
فترى المؤمن في أي مجتمع وفي أي أرض كان هو على مبدئه، هو على منهجه، هو على قِيَمه وفضائله، ليس تركه للمعاصي لأجل بلده أو حياء من خَلْق من أهله أو ممن يعرفه، ولكن تركه للشرّ مراقبة لله وطاعة لله: مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ [يوسف:23]، فهو يترك السوء خوفًا من الله، ويبتعد عن الجرائم خوفًا من الله.
ومن آثار الإيمان أنك ترى المؤمن كلما نظر إلى هذه المعاصي والمخالفات، وكلما رأى من انغمس في الشهوات أو انخدع بالشبهات؛ تراه يزداد حبًّا لإيمانه وخوفًا على إيمانه، فيرى أمَمًا قد انحرفت عن منهج الله المستقيم، وضلّت عن سواء السبيل، فيتذكّر قول الله: أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً [الفرقان:44]، ويتذكّر قوله: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ [يوسف:103]، فهو كلما رأى المنحرفين وأعمالهم السيئة وطرقهم الضالّة سعى ناصحًا فيهم، وداع إلى الله بعلم وبصيرة وحكمة، فإن استُجِيب له فالحمد لله، وإلا فلسان حاله يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به، وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلاً.
ومن آثار الإيمان على المؤمن حسن تعامله مع الخلق، فهو يتعامل مع الخلق بالقول الحسن والفعل الحسن امتثالاً لقول الله: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا [البقرة:83]، وقوله: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا [الإسراء:53]. فهو يتعامل مع عباد الله بحسن القول وحسن العمل، فليس مفاخرًا عليهم، ولا مُدّعيًا تعالٍ عليهم، لا يخدعه نَسَبُهُ، ولا يغرّه منصبه، ولا يملأ قلبَه كِبرٌ مالُه، وإنما قلبه مؤمن حقًّا، فهو يتعامل مع الناس بالقول الحسن والخلق الحسن، وخالِقِ الناسَ بخلق حسن.
من آثار هذا الإيمان أنك ترى المؤمن مهذب اللسان، بعيدًا عن الكذب، بعيدًا عن النميمة، بعيدًا عن الغيبة، بعيدًا عن البهتان، لا يغتاب مسلمًا، ولا يسعى بنميمة، ولا يكذب ولا ينسب كذبًا على مسلم، ولا يحاول الحطّ من قدره، ولا يحاول إهانته مهما كانت الظروف، يتقي الله، ويراقب الله في أحواله كلها.
من آثار هذا الإيمان أنك ترى هذا المؤمن صادق اللسان، قوي القلب في الخير، ذا أمانة ووفاء، وصِدْق في الحديث ووفاء بالعهود، وأمانة فيما اؤتمن عليه، إيمانه يدعوه إلى ذلك، إيمانه يدعوه إلى الخير، ويقوده إلى الخير، وهذا الإيمان يزداد في القلب المؤمن، ولذا إذا خالطت بَشَاشَة الإيمان قلب المؤمن فإنه على خير بتوفيق من الله.
من آثار الإيمان في قلب العبد أنك ترى تصرّفاته كلها تنبثق عن إخلاص وصدق وحب الخير للأمة أجمع، فهو داع إلى الله بلسانه، وداع إلى الله بأعماله، وداع إلى الله في تعامله، فمن عامله فقلبه مطمئن إليه. المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، من عامله فإنه مطمئن إليه، يرى الإيمان الصادق الذي يحمله على الوفاء واحترام أموال الناس وعدم الخيانة والغش والخداع، الناس في سلامة من شرّ لسانه، فلا يظلمهم بالأقوال ولا يَبْهَتُهُم ولا يقذفهم ولا يرميهم بالعظائم: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58]. وهم سالمون من شرّ يده، فلا تخطّ يده كلامًا سيئًا ولا كذبًا ولا بُهْتانًا ولا تعدّيًا على الناس في أموالهم وأجسادهم.
المؤمن هكذا خير كله، إن تكلّم فقول حسن، وإن عمل فعمل حسن، وإن عاملته فالمعاملة طيبة، وإن جاورته أحسن الجوار، وإن صاحبته أحسن الصحبة، فأنت مطمئن إليه؛ لأن هذا الإيمان الصحيح قد ملأ قلبه فاستنار قلبه بالإيمان فظهرت تلك الأخلاق والأعمال والفضائل.
لمّا ابتُدِئ الوحي بمحمد ، وأصابه من الهمّ ما أصابه، فأتى لزوجته خديجة يعرض عليها ما حصل له، فقالت لكمال يقينها وعقلها: (كلا والله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتُقْرِي الضيف، وتصل الرحم، وتكسِب المعدوم، وتُعين على نوائب الحق)[3]. فعلمت بكمال عقلها أن الله من كمال فضله لا يخزي من تلك أفعاله: واصلاً للرحم، مُقْرٍ للضيف، كاسبًا للمعدوم، صادقًا في الحديث، قالت: (كلا والله لا يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَلّ، وت+ب المعدوم، وتُعِين على نوائب الحق)، فتلك خصال كان محمد متخلّقًا بها قبل أن يوحى إليه، كان الصدق والأمانة خُلُقه، تعرفه قريش من بين سائر بني هاشم بأنه الصادق الأمين، فيصفونه بالصدق، ويصفونه بالأمانة، وربك أعلم حيث يجعل رسالته، فاختاره الله لهذا الأمر العظيم والمهمة الكبرى ليكون سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه أبدًا دائمًا إلى يوم الدين.
أيها المسلم، إن الإيمان حقيقته في القلب، وآثاره في الجوارح، والأعمال جزء من الإيمان، ولا انفصال بين إيماننا وأعمالنا، فأعمالنا من إيماننا، ولا يمكن أن يكون إيمان خالٍ من عمل، وما ذَكَر الله الإيمان في القرآن إلا وذكر الأعمال مقرونة معه، إنما أتى النقص والقصور فينا عندما يضعف الإيمان من قلوبنا، فكل من ضعف الإيمان في قلبه فعلى قدر ضعف الإيمان تكون المخالفات، وتكون الجرائم والأخطاء، كلما ضعف الإيمان في القلب كثرت الجرائم والمخالفات، وقَلّ الحياء، نسأل الله العافية.
فعلى المؤمن أن يتقي الله في إيمانه، ويراعي أخلاق الإيمان؛ ليكون من المؤمنين حقًّا، فليس الإيمان بالتحلِّي ولا بالتمنِّي، ولكن ما وَقَرَ في القلوب، وصدَّقه العمل: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [الأنفال:2].
فالمؤمن حقًّا مستقيم على الطاعة، مستقيم على الهدى، يعامل الخلق بمثل ما يحب أن يعاملوه به، متذكّرًا قول النبي : ((لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يحبّه لنفسه))[4]. وتلك مرتبة الكمال لمن أراد الله به الخير، ووفّقه للعمل الصالح، وربك يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم.
[1] أخرجه مسلم في الإيمان (34) من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
[2] أخرجه البخاري في الإيمان (16)، ومسلم في الإيمان (43) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
[3] أخرجه البخاري في بدء الوحي (3)، ومسلم في الإيمان (160) من حديث عائشة رضي الله عنها.
[4] أخرجه البخاري في الإيمان (13)، ومسلم في الإيمان (45) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
الخطبة الثانية
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين.
أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا الله تعالى حقّ التقوى.
عباد الله، يقول : ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم))[1]، هذا هو الإسلام الحق، وهذا هو الإيمان الحق، فدعوى الإسلام مع إلحاق الضرر باللسان واليد، ودعوى الإيمان مع سفك دماء المسلمين ونهب أموالهم وتدمير ممتلكاتهم؛ أمر مستحيل، فهذا ينقض هذا، فالمؤمن حقًّا أَمِنَه الناس على دمائهم، فلا يخشون منه ظلمًا وعدوانًا، ولا يسعى في فساد، ولا يسعى في إلحاق الضرر، ولا يسعى في تدمير الأمة، بل هو يتقي الله في كل شيء، ويعلم لإخوانه المسلمين حق الإكرام والاحترام، هو يبذل جهده في الخير لا يبذله في السوء، ويُسخّر فكره وعقله ورأيه فيما يسعد أمته، لا فيما يلحق الأذى والضرر بها.
أيها الإخوة، وإذ نُشِر ما نُشِر منذ يومين عن بعض الفئات المنحرفة عن سبيل الحق والاستقامة ممن اكتُشِف لهم أوكار سوء ومخابئ فساد ومجموعة من أنواع الأسلحة المختلفة، هذه الفئة وأمثالها الذين عملوا هذا العمل أيشكّ مسلم في أخطائهم؟ أو يشكّ مسلم في أنهم لا يريدون بالأمة خيرًا، وإنما يريدون الشر والبلاء؟ ولكنّ الله سَلَّم، وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ [فاطر:43]، نسأل الله السلامة والعافية.
إن الواجب على المؤمن حِيَال هذه الأمور أن يكون مُتّقيًا لله، حريصًا على سلامة أمته، لا يتواطأ مع المجرمين، ولا يرضى بأفعالهم، ولا يقرّهم على أخطائهم، ولا يتعاون معهم بأي وسيلة كانت، بل هو بعيد عن هذا الأذى والضرر؛ لأن هذه الأشياء التي ذُكِرت وبُيِّنت ـ والعياذ بالله ـ كلها ضرر على الأمة، وكلها خطر. وماذا يريد بها أولئك؟ يريدون أن يدمروا بها الأمة، أن يسفكوا الدماء المعصومة، ويدمروا الممتلكات، وينشروا الفوضى، ويحدثوا في الأمة ما يريدون من الشر والبلاء، ولكنّ الله سَلَّمَ، وحفظ الأمة من هذه المكائد، وله الفضل والمنّة دائمًا وأبدًا.
وعلى المسلم أن لا يكون عونًا لأي مجرم ولا مساعدًا له ولا راضيًا به ولا مُؤْوِيًا له ولا مؤجّرًا له ولا ساكتًا عنه؛ لأن هذه المصائب لابد أن يكون بين أفراد الأمة تعاون قوي لكفّ هذه الشرور والبلايا التي يريد بها أعداء الأمة بالأمة الضرر، ويأبى الله ذلك والمؤمنون، فهذه أمور خطيرة وأمور ضارّة لا تتفق مع الإيمان الصادق الذي يحبّ لإخوانه ما يحب لنفسه، ويرضى لهم ما يرضى لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، أمّا هذه الأمور الباطلة وهذه الأوكار الخطيرة فإنها بلاء على الأمة.
فالواجب تقوى الله والالتفات في الخير، واجتماع الكلمة، وأن لا يُمَكّن من يريد بالأمة شرًا من مراده، بل يؤخذ على يده، فلا يجوز التغاضي ولا السكوت ولا الرضا بهذه الجرائم الخطيرة؛ لأنها ضرر على الأمة في حاضرها ومستقبلها.
نسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يردّ عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وأن يجعل من أرادهم بسوء أن يجعل تدبيره تدميرًا عليه، وما أراد من سوء أن يكون عليه آثاره السيئة، إنه على كل شيء قدير، وأن يهدي ضالّ المسلمين، ويثبّت مطيعهم، ويرزق الجميع التوفيق لما يحب الله ويرضاه والسعي فيما يصلح الأمة في حاضرها ومستقبلها، إنه على كل شيء قدير.
واعلموا ـ رحمكم الله ـ أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ...
[1] أخرجه البخاري في الإيمان (10)، ومسلم في الإيمان (40) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
| |
|